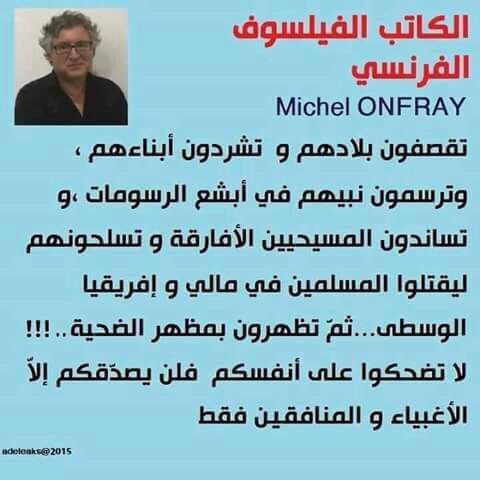حينما افتتح البوعزيزي مشهد هذا العقد الميلادي، فتفجّرت منه عيون الربيع العربي، كان العقد السابق له، عقدٌ قدّم سردية مختلفة جداً.
لخّص هذه المقارنة الكاتب السعودي عبد العزيز الخضر حينما قال مرّة بأن: "سردية محمد البوعزيزي غلبت سردية محمد عطا". وكان بين المحمدين عقدٌ بالتمام والكمال.
محمد عطا كان أحد أهم شخصيات عملية الحادي عشر من سبتمبر/أيلول الإرهابية في نيويورك، وكانت ترمز لسردية الصراع الأبدي ومركزية العنف، وافتتحت العقد الأول من القرن العشرين وسيطرت على القصص المختلفة والجدل العام في العقد كله.
العودة للأمة وأولوية المشاركة السياسية والاستماع أخيراً للشعوب كانت قيم الربيع العربي.
في المقابل، وبعد عقدٍ كامل كانت سردية الربيع العربي مختلفة تماماً: سردية تربط بين الاستبداد والاحتلال، تربط بين التحرر والاستقلال من المستعمِر وبين التحرر والاستقلال من المستبد، ذلك الارتباط القديم الذي قال عنه أحدهم يوماً: "لقد رحل المستعمِر الأحمر، وبقي لدينا المستعمر الأسمر"، فكانت سردية الربيع العربي هي أخيراً مناقشة مصدر لبلاء العربي المبين المتمثّل في هذا المستعمر الأسمر الجاثم على رقاب الأمة العربية والإسلامية؛ المتمثّل في الطغمة الفاسدة المستولية على صناعة القرار والمحتكرة للعمل السياسي والديني والثقافي والاجتماعي.
العودة للأمة، وأولوية المشاركة السياسية والاستماع أخيراً للشعوب.. كانت قيم الربيع العربي.
سردية الربيع العربي الفريدة لم تكن هندسة "انقلابات عسكرية" بل ضغط شعبي عارم، وفوران شعبي في لحظة فارقة. يضغط على كافة القوى الاجتماعية والسياسية والمؤسسات للانحياز للشعوب، وتقديم الحفاظ على الشعوب وخياراتهم. مقابل تلك المجازر والحروب الأهلية والإرهاب الرسمي الذي يصنعه المستبد كل مرة ليبرر وجوده، ولكي يضع الناس والعالم أمام خيار الجحيم، أو القبول به كفرد مستبد.
المهم أن السردية التي قدمها الربيع العربي لم تكن بالحسبان، لم تكن احتلالاً ولا انقلاباً عسكرياً، بل انحياز قوى وطنية في لحظات ضغط شعبي عارمة لخيارات الشعوب ورفض الانخراط في جرائم الاستبداد ومجازره الوحشية في قتل أبناء شعبه وعمومته.
فكرة الانشقاق التي قدمها الربيع العربي مثلاً كانت صادمة للاستبداد ومفاجئة له، لأنها تعني أن المؤسسات المختلفة والأفراد المختلفين على رأس المؤسسات المختلفة بدؤوا بالانحياز للخيارات الشعبية العامة، ورفض الانخراط في مهاجمة الشعب وقواه. وبالتالي، يتحلّل الاستبداد ويتفسّخ من داخله ليتيح للقوى الشعبية ترشيح الأسماء المنحازة لها كخيارات وطنية شعبية مخلصة لم تتلطخ أيديها بالدماء، فشمس الحرية والضغط الشعبي تذيب تمثال الجليد لهؤلاء المستبدين والطغاة والجبابرة.
السردية التي قدمها الربيع العربي لم تكن احتلالاً ولا انقلاباً عسكرياً بل انحياز قوى وطنية في لحظات ضغط شعبي عارمة لخيارات الشعوب.
وهذه بالضبط كانت سردية الربيع العربي. أما لماذا كلّ مرّة؟ قال أحد مؤرخي الثورات مرّة بأن الانتفاضات الشعبية التي تفور، كانت تبدو مستحيلة حتى إذا وقعت بدت للكل حتمية لا مفر منها!
انسداد الأفق السياسي، وإغلاق كافة أشكال العمل السياسي والاجتماعي والثقافي والديني التي كانت تعمل بشكل طبيعي، يعني تهيئة شرط مهم لأهم شروط الاهتزازات المخيفة على أسوأ الأحوال، أو الانتفاضات الشعبية الضاغطة نحو التحول للحكم الشوروي في أحسنها.
لذلك، كانت سردية الربيع العربي، ليست مجرّد تاريخ أو سنوات محددة، بل حالة ونتيجة مرتبطة بظروف موضوعية وظروف اجتماعية وسياسية ودينية شكّلت في النهاية موجة شعبية جديدة في العالم، هذه الموجة رغم انتكاساتها لا تزال تحاول استعادة أنفاسها وتحدّي القمع المضاد، والعدة والعتاد، لقوى الاستبداد.
حينما تحدث صاموئيل هنتنقتون عن الحركة الديمقراطية في العالم، كان من أهم ما قدّمه قصة "الموجات الديمقراطية" في العالم، حيث قسّم التحولات الديمقراطية في العالم إلى ثلاث مراحل سابقة، الأولى منها في القرن التاسع عشر، والموجة الثانية كانت بعد الحرب العالمية الثانية، بينما الموجة الثالثة هي في الثمانينيات الميلادية التي تحولت فيها العديد من دول أميركا اللاتينية ودول أخرى نحو الديمقراطية.
يمكن أن يشكل الربيع العربي الموجة الرابعة للديمقراطية مع عدم وضوح تحولات هذه الموجة وانتكاساتها اللحظية.
لذلك، يعتقد بعض المتابعين والباحثين أن الربيع العربي يمكن أن يشكّل الموجة الرابعة للديمقراطية، مع عدم وضوح في بعض البلدان التي اجتاحتها تغيرات الربيع العربي، وعدم وضوح تحولات هذه الموجة وانتكاساتها اللحظية، ومشاريع استعادتها المستقبلية.
في الموجة الثالثة، كانت المؤسسات الدينية والكنائس والاجتماعات الدينية في دول أميركا اللاتينية ودول أوروبا الشرقية مجالاً مهماً لصناعة تجمُّع مدني بديل عن كافة أشكال الاجتماع المدني المحظورة في تلك البلدان، ومن كل تلك الاجتماعات تَشكّلت بواكير الاحتجاج والرفض، والثورة التي ألهمت الشعوب وحررتها ضد القمع والاستبداد والظلم والعسف.
وفي تلك الظروف وقبلها تَشكّل -مثلاً- "لاهوت التحرير" في البرازيل وغيرها في صياغة فكر ديني مسيحي حر يرفض الاستخذاء ويرفض الخطاب الكنسي (الجامي) الذي يطوّع الناس لخدمة الفرد ويعارض حكم الممثلين والشعب، وبالتالي كان الخطاب الكنسي التقليدي آنذاك قبل لاهوت التحرير خطاباً يطوِّع المجتمع تحت تسلُّط الدولة وعسفها، فكان لاهوت التحرير مجهَّزاً بشكل ديني ولاهوتي وبالمنطق المسيحي التقليدي نفسه لمحاربة الاستعباد والظلم؛ لذلك، يَعتبر نفسه "تحريراً".
وبنفس منطق الاستبداد وبنفس طرائقه التقليدية في التبرير، يكون منطق الاحتجاج والتحدي الشعبي وإنقاذ الخطاب الديني نحو التحرير. باختصار، كانت تلك سردية الربيع العربي. ونعم، هي كل مرّة كذلك.
جميع المقالات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن TRT عربي.
المصدر: TRT عربي