نبضات المحبين (3)
ظاهرة القرضاوي بين الحركة والأمة
رحل العلامة يوسف القرضاوي -رحمه الله تعالى- بعد نحو قرن، وقد امتد به الزمان حتى إنه اعترض -قبل أسابيع من موته- على دعاء أحد جلسائه له بطول العمر؛ لأنه تعب، ولأنه كان في شوق إلى لقاء ربه. وقد أتاح هذا العمر المديد للشيخ أن يجرب كل شيء: كمًّا ونوعًا، شهرةً وخفوتًا، ثناءً وذمًّا، توافقًا واختلافًا، سجنًا وحرية، وأن يجوب أصقاع العالم وأن يُمنع أيضًا من دخول بعض الدول، وأن ينزوي عن المشهد العام منذ انقلاب 2013 في مصر، ليموت بعد نحو 9 سنوات فيما يشبه العزلة.
عاصر الشيخ أنظمة سياسية عديدة: النظام الملكي ونظام ثورة يوليو 1952، ثم الأنظمة اللاحقة مرورًا بثورات ما سمي بالربيع العربي التي كان أحدَ الوجوه البارزة فيها، الأمر الذي سبّب له الكثير من المتاعب في نهاية عمره. وخلال هذا القرن أنجز الشيخ الكثير جدًّا حتى كان -بحق- شيخًا للإسلام المعاصر، وشكّل ما يشبه المرجعية أو "عالِم الأمة" الذي لعب دورًا بارزًا في التحولات الحديثة في الخطاب الإسلامي المعاصر: فقهًا وسياسةً ودعوة وحركةً. وهذه المرجعية التي تمتع بها القرضاوي حالةٌ طارئة على الفكر الإسلامي السني، مكّنه منها استعداداتٌ وإمكانات شخصية من جهة، واستثمار أدوات حديثة (كالنشر والفضائيات والإنترنت وكثرة الأسفار وتشكيل المؤسسات) من جهة أخرى، بالإضافة إلى الدعم السياسي والمالي الذي حظي به في بعض مراحله.
اكتشف القرضاوي في مرحلة لاحقة أن "شمولية الإسلام" من صميم الشريعة التي يتناول علمُ أصولها: الحاكم (خطاب الشارع) والمحكوم عليه (المكلف) والمحكوم فيه (الفعل) ونفس الحكم، وبذلك يتحقق قوله تعالى: "قل إِن صلاتي ونُسُكي ومحيايَ ومماتي لله ربِّ العالمين لا شريكَ له وبذلك أُمرتُ وأنا أوّلُ المسلمين"
ويمكن فهم شخصية الشيخ من خلال ثلاث كلمات مفتاحية، هي: شمولية الإسلام، والأمة، والشريعة. وعلى أساسها سأقدم قراءة مكثفة لتشكل ظاهرة القرضاوي، مراعيًا فيها الجانب التأريخي والتحليلي.
ففيما يخص "شمولية الإسلام"، يُعتبر الشيخ خاتم الإصلاحيين الكبار الذين جسدوا هذه الفكرة، سواءٌ في تكوينه وشخصيته الموسوعية، أم في رؤيته ومشروعه: حركةً وكتابةً، وكلٌّ منهما يَعضد الآخر. وقد يعيد بعضهم فكرة "شمولية الإسلام" إلى الشيخ رشيد رضا في مرحلته الثانية بعد وفاة محمد عبده، وقد يعيدها آخرون إلى إضافات حسن البنا على رشيد رضا. والقرضاوي لا يُخفي تأثره الشديد بالبنا الذي كان أول من عرّفه بفكرة شمولية الإسلام حين استمع إليه وهو في المرحلة الابتدائية، ولكن انضمامه إلى الإخوان المسلمين في المرحلة الثانوية أحدث تحولاً كبيرًا في مسار حياته ووعيه؛ فتحول من "واعظ ديني" إلى "داعية إسلامي" يعمل من أجل "الإسلام الشامل".
ولكن القرضاوي اكتشف في مرحلة لاحقة أن "شمولية الإسلام" من صميم الشريعة التي يتناول علمُ أصولها: الحاكم (خطاب الشارع) والمحكوم عليه (المكلف) والمحكوم فيه (الفعل) ونفس الحكم، وبذلك يتحقق قوله تعالى: "قل إِن صلاتي ونُسُكي ومحيايَ ومماتي لله ربِّ العالمين لا شريكَ له وبذلك أُمرتُ وأنا أوّلُ المسلمين". أي أنه ينقل هذا -بنفَسه الحركي- من دائرة الفرد إلى دائرة الجماعة المتجاوزة للدولة القطرية.
صحيح أن إصلاحية القرضاوي قد تبدو -بالقياس إلى محمد عبده ورشيد رضا- محافظةً، إلا أنها تتصل بها اتصال نسب ومنهج.
فمن حيث النسب، اتصل القرضاوي -في أول نشأته- بحسن البنا الذي تتلمذ على رشيد رضا ثم خلَفه وانتقل من الفكرة المجردة إلى الحركة، ثم تتلمذ القرضاوي على الشيخ محمود شلتوت الذي كان معجبًا بمنهج عبده في التفسير وكتب عنه، كما تتلمذ على جيل شلتوت كمحمد عبد الله دراز الذي كان والده عبد الله دراز من تلامذة عبده، وكتب تعليقًا على كتاب الموافقات للشاطبي بوصية من محمد عبده.
أما من جهة المنهج، فقد تأثر القرضاوي برشيد رضا في التفسير والفتوى، واشتركت إصلاحيته مع إصلاحية مَن قبله في جوانب عدة، منها استعادة مفهوم الأمة، والمواءمة بين الشريعة والحداثة، وتجاوز التقليد المذهبي الفقهي والدعوة إلى الاجتهاد والتجديد، واستعادة فكرة المقاصد أو المصالح، والتوسع باتجاه آراء ابن حزم وابن تيمية. والأهم من ذلك العودة المباشرة إلى النصوص التأسيسية (القرآن والحديث). ولكن عوامل الاشتراك هذه لا تلغي التفاوت الواقع بين الإصلاحيين أنفسهم: قدُراتٍ ومُخرجاتٍ، كما لا تنفي تطورات السياق وتبدل الإشكاليات؛ ففي حين كانت إشكالية عبده ورضا كيف نتقدم كالغربيين، صارت إشكالية البنا ومَن بعده كيف نصون الهوية الإسلامية المهددة على وقع الاحتلال والصراعات الأيديولوجية الدائرة في الداخل. وقد فرض هذا التحولَ تلك التطوراتُ السياسية داخليًّا بالنسبة للدولة، وخارجيًّا في العلاقة مع الغرب الذي صار استعماريًّا بعد سقوط الخلافة.
القرضاوي كان مهجوسًا بفكرة الخلافة الغائبة شأنه شأن سابقيه، ووعى جيدًا -بحكم عمره المديد- مشكلتي الاحتلال (وفي القلب منه قضية فلسطين) والاستبداد (وفي القلب منه الصراع مع الأنظمة لإقامة دولة الشريعة)، وهو الذي سُجن أكثر من مرة ثم اضطر إلى مغادرة بلده وقضى عمره خارجه منذ مطلع الستينيات.
أما فيما يخص مفهوم الأمة، فهو مفهوم مركزي لدى القرضاوي؛ لأنه "المحكوم عليه"، أي أن خطاب الشارع لم يعد موجهًا إلى الأفراد بوصفهم أفرادًا، بل إلى مجموع الأفراد بوصفهم أمة واحدة، وبالرغم من أن البنا كان الشرارة التي قدحت هذا المعنى في نفسه طفلاً، فإنه لا يمكن اختزال القرضاوي في البنا؛ لأنه قد تجاوزه -فيما يبدو لي- من عدة جهات:
ففي حين أن أولوية البنا كانت سياسية بالمعنى المباشر (الدولة التي تقود إلى الخلافة)، اشتد تعذر إقامتها في زمن القرضاوي فحاول أن يقيمها رمزيًّا وعمليًّا بوصفها جماعة متخيلة متجاوزة لأطر الدول القطرية. وفي حين بقي البنا محصورًا في إطار الحركة والتنظيم، فإن القرضاوي قد خرج -في نشاطه وحجم تأثيره- من ضيق الحركة إلى سعة الأمة، فاستعفى من العمل التنظيمي الإخواني في أواخر السبعينيات، ورفض تولي منصب المرشد العام للإخوان المسلمين مرتين، وكان لافتًا أن سبب رفضه في المرة الثانية هو أنه يريد أن يكون مرشدًا للأمة لا مرشدًا للجماعة، وقد اشتد وعيه بتجاوز الحركة إلى الأمة في الثمانينيات والتسعينيات. وإذا كان البنا قد وضع أطرًا حركية، فإن القرضاوي حاول أن يضع أطرًا متجاوزة للحركة استطاع بها أن يخترق التيارات الإسلامية المتعددة، إذا استثنينا النقد السلفي المبكر لكتابه "الحلال والحرام"، مع ما تمتع به من شخصية تصالحية داخليًّا (أعني في الدائرة الإسلامية عموما) وخارجيًّا (أعني خارج الإسلام وخاصة المسيحية واليهودية غير الصهيونية).
فالقرضاوي كان مهجوسًا بفكرة الخلافة الغائبة شأنه شأن سابقيه، ووعى جيدًا -بحكم عمره المديد- مشكلتي الاحتلال (وفي القلب منه قضية فلسطين) والاستبداد (وفي القلب منه الصراع مع الأنظمة لإقامة دولة الشريعة)، وهو الذي سُجن أكثر من مرة ثم اضطر إلى مغادرة بلده وقضى عمره خارجه منذ مطلع الستينيات.
وبفضل وعيه بالاحتلال والاستبداد، كانت فلسطين قضية مقدسة لديه، وتورط من أجلها في شرعنة العمليات الاستشهادية، الأمر الذي سبّب له مشكلة سياسية، ولكنه عاد واعتبرها لاحقًا عمليات مصلحية، وأن جوازها مرهون بتحقيقها للمصلحة. كما أنه تجاوز الأطر المؤسسية الدينية التقليدية التي سيطرت عليها دولة ما بعد الاحتلال، والتي ارتهنت إلى الحلين الاشتراكي والرأسمالي أثناء الحرب الباردة، وهنا تبلور لديه لاحقًا -في 2004- فكرة الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي أراده بديلاً رمزيًّا ومظلة مرجعيّة جامعة تعوّض الخلافة التي كانت تعبر -تاريخيًّا- عن الوحدة المرجعية والسياسية للأمة المسلمة.
أما بخصوص الشريعة، وهي الكلمة المفتاحية الثالثة في شخصية القرضاوي، فقد شكلت عصبَ رؤيته وحياته، ووسمته بالسمة الفقهية المُجدِّدة بالمقارنة مع مشايخ عصره، كما أنه تجاوز فيها البنا الذي كان مهجوسًا بفكرة "دولة الشريعة" إلى إطار أوسع من فكرة الدولة، وهو ما جعله في تصور بعض المستشرقين يجسد ظاهر "المفتي العالمي" (Global Mufti). وقد برز منزعه الفقهي مبكرًا في قريته ثم تطور لاحقًا متأثرًا بسيد سابق صاحب "فقه السنة" الذي لقي نقدًا من قبل فقهاء التقليد المذهبي وقدم لكتابه حسن البنا، مرورًا بكتاب "الحلال والحرام" والكتب الفقهية اللاحقة، ومنها أطروحته للدكتوراه في "فقه الزكاة" التي ناقشها في قاعة الشيخ محمد عبده في الأزهر مطلع السبعينيات.
الأفق العام للشيخ هو إعادة الشريعة إلى الفضاء العام الحديث (السياسي والاجتماعي) داخل دول ما بعد الخلافة، وقد وضعه هذا في موقف احتجاجي على "إسلام الأنظمة" التي حاولت صياغة إسلام يتواءم مع مقتضيات الدولة القطرية ونظمها الحاكمة، ومن ثم سيطرت على المؤسسات الدينية والفضاءين السياسي والاجتماعي. في المقابل شكل الفضاء الأوروبي فضاءً رحبًا لتوطين الوجود الإسلامي فيه بدءًا من أواخر السبعينيات وصولاً إلى إنشائه مجلس الإفتاء الأوروبي (1997)، حيث تحول الوجود الإسلامي في الغرب من فكر ضرورة -بالمعنى الفقهي- إلى ضرورة بالمعنى الحركي والدعويّ.
والمراقب لمسار الشيخ الفقهي يلحظ فيه تطورًا من مرحلة "ابن القرية والكتّاب"، ثم تأثره بالشيخ البنا، ثم مرحلة الأزهر وتأليف "الحلال والحرام"، مرورًا بـ"فتاوى معاصرة" (1991) و"الشريعة والحياة" (1996)، وصولاً إلى حقبة الثورات العربية. فانشغالاته الفقهية التي بدأت تقليدية، سرعان ما امتزجت بالاهتمامات الحركية، وتجاوزتها في بعض الأحيان، ولكنه عاد في أواخر حياته إلى بعض الاهتمامات التقليدية (الآداب، وفقه الصلاة، وأجزاء من التفسير ليس فيها ما هو مميز). ومن الواضح أن نشاط الشيخ وحركته أثرت في فكره وبالعكس؛ فمع تشكل مرجعيته في أخصب مراحل حياته -في الثمانينيات والتسعينيات- تمتع بمرونة وذكاء مكّناه من استثمار الأفكار والوسائل الحديثة (خاصة الفضائيات والإنترنت)، وتبني الاقتراحات التي كان يطرحها عليه بعض زملائه أو بعض الشباب من حوله، فضلاً عن قدرته على استثمار موضوعات المؤتمرات والمحاضرات التي كان يُدعى إليها -بكثافة- خلال هذه المرحلة.
أما من جهة المنهج الفقهي، فقد مكّنته انشغالاته الحركية وتشكل مرجعيته من تعزيز نزعة عملية، هي نزعة فقهية بالأساس، ولكنه تحرر من أطر التقليد المذهبي؛ تأثرًا بالشيخ مصطفى الزرقا رحمه الله لينهل من عموم الإرث الفقهي ويتبنى التيسير عبر انتقاء ما يراه ملائمًا لأغراضه العملية من التراث الفقهي الواسع، وما هو أوفق للمصالح التي يقدرها سواءٌ للحركة أم للأمة (يختلط الأمر لديه أحيانًا).
وقد لحظ عبد الحليم أبو شقة أواخر الثمانينيات أن فتاوى القرضاوي تختلف عن فتاوى الشيوخ التقليديين من حيث إنها فتاوى مدللة لا تتعصب لمذهب، وتعيش واقع الناس، وتذكر الحكم مقرونًا بحكمته، وتخاطب العقل المعاصر. وفي رأيي أنه امتزج لدى القرضاوي الفقهي بالدعوي، الأمر الذي ربما حمل له انتقادات بعض أهل الصنعة الفقهية حيث رأوا فيه داعية أكثر من كونه فقيهًا بالمعنى التقليدي.
تيسير الشيخ الانتقائي (الذي ربما أوقعه في عدم الاتساق أحيانًا)، كان محكومًا بفكرة توكيد مرجعية الشريعة الرحبة التي لا تصطدم بالعصر، وهو ما بدأ به "الحلال والحرام" الذي كتبه لمسلمي الغرب أصالة، وحاول فيه توسيع دائرة الحلال في تناول المستجدات الحديثة كاللباس والموسيقى والفنون وغيرها، في مسلك أشبه بمسلك ابن حزم في توسيع المباح، وإن كان الشيخ لا يطرد في ذلك، فله فيه خيارات مُشدِّدة في حين أننا نجد في التراث الفقهي آراء رحبة لم يجر فيها على طريقته في انتقاء الأيسر، أي أن القرضاوي وسع دائرة الفقه خارج الآراء السائدة ليستوعب الحياة، ولذلك يغلب عليه أنه لا يقول بمسألة ليس له فيها إمامٌ يحتمي به، ولو من خارج المألوف أو السائد.
لم يشكل الخطاب الإصلاحي لدى عبده ورضا التيار الرئيسي (main stream)، وإن تمتع بتأثير قوي، إذ التيار الرئيسي كان ممثلاً في التيار المحافظ الذي تمثله المؤسسات الدينية الكبرى وممثلوها. ولكن أهم منجزات القرضاوي تحويله الخطاب الإصلاحي -في صيغته "القرضاوية"- إلى خطاب شعبي "عالمي"، وقد برز ذلك منذ السبعينيات وما بعدها، حيث تصدى لقضايا العصر كتوسيع دائرة الحلال، والمواءمة بين الشريعة والحداثة، وترشيد الصحوة الإسلامية، ومجابهة ظاهرة الغلو في التكفير، ونقد جماعات العنف وفكر سيد قطب، ومجابهة الحلين الاشتراكي والرأسمالي، والسجال مع دعاة العلمانية، والمساهمة في البنوك الإسلامية، وغير ذلك، وكل هذا عزز من تشكل مرجعيته في الثمانينيات والتسعينيات، وقد تُوجت ببرنامج الشريعة والحياة عبر الجزيرة (1996) وموقع إسلام أونلاين على الإنترنت (1998)، وبالمؤسسات التي أنشأها بعد ذلك مما سبقت الإشارة إليه.
ولكن مع تشكل مرجعيته في الثمانينيات، بدا خطابه أكثر تصالحًا مع الغرب، وخاصة في مرحلة التسعينيات التي ساد لديه فيها توجه نحو تقوية الوجود الإسلامي في الغرب بعد انتهاء الحرب الباردة وخفوت التيارات الأيديولوجية والتقارب الإسلامي القومي، في حين أنه كان حاد النبرة في سلسلة "حتمية الحل الإسلامي" التي بدأت في 1970، وفي صراعه مع العلمانيين مطلع الثمانينيات، وهذه النزعة السجالية كانت سمة سائدة لدى معاصريه في تلك الفترة من مختلف الأطراف.
يوضح هذا المسار الفكري التاريخي لشيخ الإسلام المعاصر حجم المناكفة السياسية والضحالة الفكرية التي يتمتع بها خصومه اليوم في الثورة المضادة؛ إذ أرادوا أن يختزلوه في "الإخواني" فوقعوا في تناقضات فجة، ألخصها في أمور:
الأول: تجاهل هذه المعطيات والوقائع التي امتدت عبر نحو 7 عقود، بل كانوا هم أنفسهم فيها له من المؤيدين والمتعاطين مع مرجعيته، فالشيخ خرج من ضيق التنظيم إلى سعة الفكرة، بل إن التنظيم نفسه لم يكن له كبير دور في صناعة القرضاوي الذي شكا هو نفسه من إهماله له ومن فقره الفكري وعدم عنايته بالعلماء.
الثاني: كان للشيخ تقليد إنساني دائم يحرص فيه في برنامج "الشريعة والحياة" على تقديم العزاء في عامة الشخصيات العامة التي تموت، وقد رثى فيه الكثيرين جدًّا ما بين (1996-2013)، في حين أن بعض أصدقائه بالأمس وخصومه اليوم لم يجرؤوا على مجرد كتابة كلمة في وداعه؛ لأن ما يحركهم هو أفق الدولة القطرية ورغبات النظم السياسية، ومن ثم فقدوا الحرية حتى ممارسة نشاط إنساني طبيعي! وإلا فما معنى أن ينعى شيخ الأزهر الشيخ أحمد الطيب -مثلاً- ملكة بريطانيا ويصمت تماما عن القرضاوي ابن الأزهر والشخصية المصرية الأبرز في التاريخ الحديث؟
الثالث: أن رثاء الشيخ لبابا الفاتيكان في برنامج الشريعة والحياة سبّب له انتقادات واسعة، وهو الذي استوسع رحمة الله، في حين أن من يزعمون السماحة والدعوة إلى السلم من خصومه ضيقوا رحمة الله حتى إنها لم تشمل القرضاوي وخصوم الأنظمة التي يدورون في فلكها!
حاولت أن أقدم هنا قراءة فكرية تاريخية للقرضاوي بوصفه علامة بارزة على تطورات الفكر والفقه والسياسة، مع بعض الإشارات النقدية التي يحتملها السياق، وإن كانت كتاباته في علوم الشريعة ونشاطه خلال الثورات العربية يحتاج إلى نقاش نقدي مفرد. رحم الله الشيخ وعوّض هذه الأمة خيرًا.
التجربة التي عمَّقت فهمي للشريعة وخبرتي بالحياة
أ. خديجة بن قنة
تاريخ النشر: السبت, 02/19/2022
رنَّ الهاتف مسجِّلا على شاشته الصغيرة اسم المدير العام لقناة الجزيرة وضاح خنفر. وكانت فاجعة رحيل الزميل ماهر عبد الله مقدِّم برنامج «الشريعة والحياة» في حادث سيارة في الحادي عشر من سبتمبر عام 2004م لا تزال جراحها لم تندمل بعد في قلوبنا. وسألني المدير العام إن كنت أرغبُ في تقديم برنامج «الشريعة والحياة»، ورددت فورًا: هل تراني جديرة بالجلوس أمام قامة عالمٍ بحجم ووزن العلامة الدكتور يوسف القرضاوي؟!
لم يكن معهودًا حينها إدارة النساء لبرامج دينية في الفضائيات العربية، وكان للشيخ يوسف هيبته ووقاره، ولم يكن في رصيدي من زاد المعرفة الدينية ما يشجعني على خوض التجربة.
دخلتُ الاستوديو في شهر سبتمبر من عام 2004م لتقديم البرنامج مرتبكة خَجْلَى، وكان واضحًا لعيْن الرقيب المتمرِّس أن بداياتي في البرنامج افتقدت عنصر الجرأة، التي تستدعي ما يُعرف عند الإعلاميين بـ «الاتصال البصري المباشر»، فقد كانت جُرأتي تصطدم بهيبة العالِم، كلما حاولتُ النظر إليه وجها لوجه.
مع الوقت بدأتُ أدخل في جلباب البرنامج الذي كان يحتل فيه فضيلة الشيخ القرضاوي دور البطولة المطلقة، بسعَة علمه، ورحابة أفُقه، وتبحُّره في مواضيعه. وكان الشيخ يوسف هو الركن الأصيل الثابت في البرنامج، بينما كان المذيعون المقدِّمون، ضيوفًا يتغيرون حسب مقتضيات العمل.
وكان فضيلة الشيخ القرضاوي يستقطب شرائح عريضة من الجمهور إلى برنامجه. وكان ذلك موثَّقا بنِسَب المشاهدة العالية التي كان يحظى بها «الشريعة والحياة»، في عمليات رصد اتجاهات الجمهور.
وكان الناس يتداولون حلقات البرنامج على أقراص مدمجة قبل أن يشهد الإعلام ثورة التكنولوجيا الحديثة، ويروج استعمال النواقل الإلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مثل: يوتيوب وتويتر وفيسبوك.
كان الشيخ حريصًا على مبدأ التنوع في اختيار المواضيع، وكان للإسلام السياسي والممارسة السياسية والديموقراطية نصيب من النقاش، رافقته دومًا دعوتُه الحركات الإسلامية للتقويم والمراجعة الذاتية.
لم يكن الدكتور يوسف القرضاوي محتكِرًا للنقاش في برنامجه، فقد اتَّسع صدره لاستيعاب مداخلات كثيرة من الضيوف، من المفكرين والعلماء الذين قدَّموا رؤى ووجهات نظر تتفق أحيانًا مع رؤيته، وتختلف أحيانًا أخرى معها.
ومثلما اتسع أفق الشيخ لاحتواء علماء ومفكرين اختلفوا معه في الرأي؛ اتسع أفقه أيضًا لاحتواء كل المواضيع المطروحة على الساحة بلا استثناء، إذ لا أذكر أنه اعترض يومًا على فكرة أو موضوع مهما كانت درجة حساسيته.
كانت حواراتي مع الشيخ القرضاوي في «الشريعة والحياة» تجربةً لا تُنسَى؛ أثرتْ بها حياتي، وأسعدتْ قلبي، وعمَّقت فهمي للشريعة وتجربتي في الحياة. كما أثرتْ وأسعدتْ ملايين من مشاهدي قناة الجزيرة في كل أرجاء العالم. ولو لم تتضمن حياتي الإعلامية سوى تلك الحوارات الممتعة المفيدة مع العلامة الشيخ القرضاوي لاعتبرتُها كافية.
.......
* أ. خديجة بن قنة مذيعة في قناة الجزيرة ومقدمة برنامج «الشريعة والحياة» سابقًا
- المصدر: «العلامة يوسف القرضاوي.. ريادة علمية وفكرية وعطاء دعوي وإصلاحي».
مع القرضاوي في «الشريعة والحياة»
الحلقة الأولى من الشريعة والحياة عام 1996
أ. حمد الشيخ
كان ذلك أول برنامج يُبث مباشرة على الهواء عبر شاشة «الجزيرة»، وتُفتح فيه قنوات الاتصال أمام الجمهور، ليطرحوا على الشيخ أسئلتهم.
أمضيت بصحبة الشيخ تسعة أشهر، قبل أن تأخذني الأخبار في تيارها الجارف، الذي غالبته منذ أيامي الأولى في دنيا الصحافة. ثم انتقلت المهمة لغيري.
وقد تبيَّن لنا منذ الحلقات الأولى: أن البرنامج حقق الهدف المرجو منه، وحاز شعبية واسعة، سواء في بلدان الوطن العربي، أو بين الناطقين بالعربية في بلاد الغرب. وظل البرنامج الأكثر مشاهدة بين برامج الجزيرة.
لقد كان ظهور الشيخ على شاشة الجزيرة بمثابة نقلة فاصلة فيما قد نسميه «إعلام الفكر الإسلامي»، وإني لأعتقد جازمًا: أن ما قدمه الشيخ من فكر ورأي في برنامج الشريعة والحياة، يستحق من تلامذته وغيرهم الدراسة العميقة، ولا تكفي عشرات شهادات الدكتوراه للإحاطة به.
......
* أ. أحمد الشيخ مستشار رئيس مجلس إدارة شبكة الجزيرة
- المصدر: «العلامة يوسف القرضاوي.. ريادة علمية وفكرية وعطاء دعوي وإصلاحي».






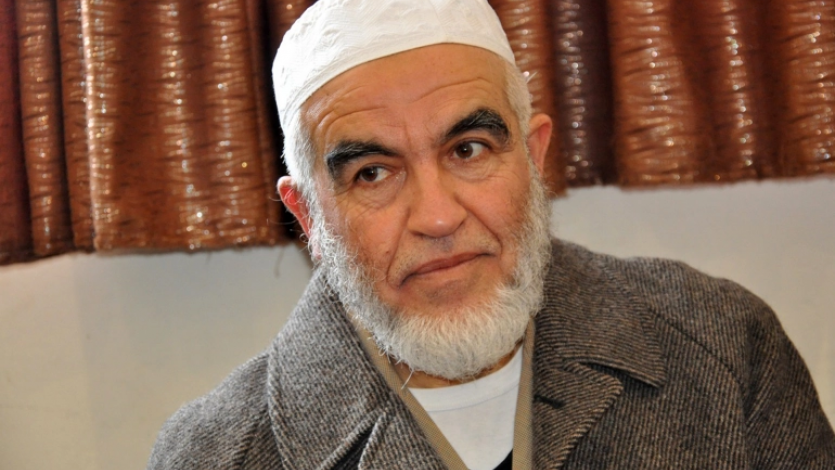

.jpg?itok=HXqGnvn3)
