أطل علينا فكر الشيخ “إبراهيم السكران” ببراعته المعتادة خلال كتابه الماتع “سلطة الثقافة الغالبة” ليسلط الضوء على ظاهرة في غاية الأهمية لا ريب أن الأمة تعاني من تداعياتها وبحاجة لتشخيص دقيق لأعراضها وعلاج ناجع لأخطارها.
الكتاب جاء في مقدمة ومدخل تنظيري وثلاثة فصول وخاتمة.
وهو حصيلة نقاشات لأسئلة طرحت محليًا، وقد كتبها الكاتب في الأعوام (1431هـ- 1433هـ).
وكعادة الشيخ في تناول المواضيع الحساسة في دراساته قدم بحثه بتوطئة جميلة لظاهرة “سلطة الثقافة الغالبة” التي رصدها السابقون الأولون من علماء وأئمة الإسلام، والتي لخصها ابن خلدون في نصه التنظيري بتميّز لا ندّ له، حين قال في الفصل الثالث والعشرون من مقدمته:
“المغلوب مولع أبدًا بالاقتداء بالغالب: في شعاره وزيّه ونحلته وسائر أحواله وعوائده؛ والسبب في ذلك أن النفس أبدًا تعتقد الكمال فيمن غلبها وانقادت إليه، إما لنظره بالكمال بما وقر عندها من تعظيمه، أو لما تغالط به من أن انقيادها ليس لغلب طبيعي، إنما هو لكمال الغالب. فإذا غالطت بذلك، واتصل لها اعتقادًا. فانتحلت جميع مذاهب الغالب وتشبهت به.. حتى أنه إذا كانت أمة تجاور أخرى، ولها الغالب عليها: فيسري إليهم من هذا التشبه والاقتداء حظ كبير”
واسترسل الكاتب لاحقًا في تحليل ظاهرة الهزيمة النفسية لثقافة الغرب الغالب، والتي ظهرت ملامحها منذ قرابة المئتي سنة في زمن “رفاعة الطهطاوي” و”جمال الدين الأفغاني”، والتي كررت نفس السلوك التاريخي السابق وهو تأويل المعطيات الشرعية لتوافق الثقافة الغالبة وخصوصًا عبر آلية حقن اللفظ التراثي بالمضمون الغربي تمهيدًا لتبيئته. وبعد سرد للعديد من الشواهد على ظاهرة الخنوع لهيمنة الثقافة الغالبة.
أجاب الكاتب على سؤال مهم:
لماذا لم تنجح ظاهرة تطويع الشريعة للثقافة الغربية الغالبة في تحقيق النهضة وحماية الشباب المسلم من الإلحاد؟
ولخص الشيخ جوابه على لسان كوكبة من المفكرين الإسلاميين الذين قدموا الإجابات البديعة التي كان من أبرزها: أن الشعور بمركب النقص لا يبعث نهضة وهو ما كرره باستمرار “مالك بن نبي“.
واللاعبون الكبار على رقعة السياسة اليوم يدركون أنه لا يمكن ضمان مصالحهم الاستراتيجية ونفوذهم الدولي إلا بتدجين كل الخطابات الدينية الحيوية الكبرى، وحقنها بفيروس الخنوع للغالب، وإماتة لياقة الممانعة فيها، لتنسجم في النهاية مع متطلبات الهيمنة الغربية.
وهذا ما يفسر إنفاق الإمبرياليات الغربية المعاصرة بسخاء لا محدود على مراكز البحوث والدراسات وتقارير الرصد الدقيق والمستمر لكل بؤر التوتر بشكل عام والحراك الديني الإسلامي بشكل خاص.
وسلط الكاتب الضوء على كم الأسئلة المهمازة التي الأساس الصريح أو المضمر فيها، هو التعارض بين الأحكام الشرعية والثقافة الغربية الغالبة. وهو أمر بلغ ذروته في السنوات السبع العجاف عقب سقوط بغداد في 2003، وحتى ثورة تونس 2010.
تناول الشيخ بعد ذلك المداخل النظرية وافتتحها بالتناظر بين الاستبداد السياسي والاستبداد الثقافي، والتي بعد صبر لأغوارها خلص في النهاية إلى أن الكثير ممن يكون ضحية الاستبداد غير واع بحاله، يتوهم بأنه مستقل وهو يرسف في الأصفاد منذ أزمان.
وسائل العلاج والخروج

ويرى الكاتب أن أهم وسائل العلاج على الإطلاق: ضخ مفاهيم العزة والكرامة والإباء والشموخ وقيمة المسلم ونحو هذه المنظومة المفاهيمية بحيث يأبى من نشأ في مثل هذه الثقافة المعتزة الشامخة أن يخنع وينصاع لمستبد سياسي لا يراك أهلًا لأن تشارك في القرار، ويطلب منك أن تمد معاريضك فقط، أو مستبد ثقافي لا يراك أهلًا لأن يكون لك منظومتك التشريعية الخاصة فيهينك لكي تكون تبعًا له، تؤمن بالحرية الليبرالية والديمقراطية وتؤول نصوص الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لكي تتوافق مع ثقافته الغربية الغالبة.
ومن المداخل النظرية أدرج الكاتب فصولًا نافعة وهي الخضوع المضمر للثقافة الغالبة، ومصائر الخضوع للثقافة الغربية، ثم انطلق بعد ذلك يفصل في فصل استقبال النص تحت عنوان “عزل النص عن التجربة البشرية”، أين أبرز الكاتب مشكلة المتوالية الفكرية حين يتبنى بعض الناس مقدمات خاطئة يسارع في تبنيها قبل الاستكشاف المسبق للوازمها فيحرص على أن يحافظ على اطراده فيها فيلتزم لوازم تنتهك في مصائرها النهائية حدود الوحي. وهو مفهوم تجريد الإسلام؛ أي جعل النص فكرة مجردة، ومؤدى كلام هؤلاء أن الإسلام لا يرتبط بأي تجربة بشرية. ولهذا يرددون: “يجب تخليص النص المقدس من التاريخ غير المقدس”، وقولهم: “النص مطلق والفهم البشري محدود والمحدود لا يحكم المطلق”.
وصار مؤدى كلامهم إلى أن هؤلاء الذين درسوا اللسانيات والهرمنيوطيقا وفلسفة اللغة والنقد الأدبي -وهذه أصول علوم الدلالة في الفكر الغربي- أفقه في معنى القرآن والحديث من أبي بكر وعمر وابن عباس وابن مسعود فكانت زندقة عظيمة.
والمراد أن تعظيم السلف والاهتداء بفهمهم للنص دلت عليه النصوص الشرعية وغالب أسرى الثقافة الغالبة لا يتفطنون لآثار إسقاط هذا الأصل الجوهري، ثم تناول الكاتب مسألة في غاية الأهمية ألا وهي توظيف مفهوم الوسطية، التي تعاني استنزافًا مكثفًا ومفاجئًا في خطابنا الثقافي المحلي.
وتسابقت المطالبات بالوسطية في وقت فات المطالبين بها أن الوسطية في القرآن نوعين، مطلوبة ومرفوضة!
وبعد تأمل وصل الكاتب إلى تقنية ذهنية مشتركة تسببت في خلق الفارق بين كل هذه الاتجاهات الفكرية (العلمانيون والليبراليون والتنويريون واليساريون) وبين أهل السنة تتيح الفهم بشكل أفضل الفارق الجوهري في عملية تشكيل المعرفة بين مدارس الثقافة الغالبة وأهل السنة.
فالطوائف الأربعة يجمعها قاسم مشترك فكري واحد، أو آلية فكرية مشتركة هي التي تسببت في مفارقتها لأهل السنة في نمط فهم الإسلام ويمكن أن نسمي هذا الميكانيزم العقلي بتجزئة الوحي.
وحصيلة هذا التحليل أن المدارس الفكرية المنزلقة في فخ الثقافة الغالبة تجدها كلها تستعمل تقنية التبعيض في تعاملها مع نصوص الوحي، وبذلك تحقق لنفسها شيئًا من الطمأنينة الداخلية بأنها ما زالت تتصل بسبب إلى الإسلام وأنها تنطلق من الإسلام وأن مشكلتها ليست من الإسلام، ونحو هذه التضميدات العاطفية لمشاعر الانشقاق المنهجي.
ولأن الثقافة الغالبة ستصطدم حتمًا ببعض المعطيات الشرعية فقد راجت بين المدارس الفكرية المعاصرة آليات التقليل والتخلص من المعطيات الشرعية كحصر الشريعة في قطعي الثبوت والدلالة، وسبب رواج هذه الفكرة هو ما فيها من الاصطلاحات الأصولية، التي مرر فيها المحرفون حمولتهم الفكرية الفاسدة.
وبسط الكاتب تحت عنوان مؤدى غثاثة الرخص، قضية أن التراث الإسلامي يعج باجتهادات شرعية كثيرة، فإذا استطعنا جمع وأرشفة رخصة كل عالم أصبح لدينا ملفًا جاهزًا لتخريج وشرعنة المعطيات التي تفرضها علينا الثقافة الغالبة.
وبين الفرق بين رخص الله ورخص المجتهدين، أي الفرق بين العمل العلمي والعمل التلفيقي. قال سليمان التيمي: “لو أخذت برخصة كل عالم -أو زلة كل عالم- اجتمع فيك الشر كله”.
والخلاصة أن استناد التيارات الفكرية المعاصرة إلى آلية تتبع الرخص يهدف شرعنة بعض عناصر الثقافة الغالبة المخالفة للنصوص الشرعية هو اتكاء على أسس هشة غير علمية.
وتحت عنوان حاكمية الذوق الغربي، سلط الكاتب الضوء على محاولة سجناء الثقافة الغالبة توظيف مفهوم التجديد أو ما يسمونه تجديد الفقه الإسلامي ليتناسب مع العصر. والذي لا يعدو كونه تحوير وتعديل الأحكام الشرعية لتتفق مع ثقافة الغالب أين يحضر الذوق الغربي في باطن هذه الأحكام كحاكم يرجع إليه ويصدر عنه.
وينتهي الكاتب إلى أن فكرة تجديد الشريعة لتوافق الذوق المعاصر، فكرة متناقضة لا يمكن العمل بها أصلًا، وأنها تفضي للتسلسل فلا تتوقف وكل من عمل بها وقع في التحكمية والعشوائية في تطبيقها فطبقوها تارة على أحكام المرأة والجهاد وتوقفوا عن تطبيقها في مواضيع أخرى لأنهم ارتطموا بشناعة نتائجها، وشتان بين شرف الوحي وانحطاط الذوق الغربي. ولهذا فإن الواجب هو أن نطور الذوق المعاصر ليرتقي إلى الوحي.
وعرض الكاتب نماذج من ضغط الثقافة الغالبة على الشعائر واستعان بصلاة الكسوف كنموذج، والهدف من معالجة هذا النموذج كشف الجهل الفادح لدى كثير من المهولين للثقافة الغالبة وتسرعهم في تبني مواقف خاطئة شرعًا وتاريخًا.

وفي الفصل الثاني للكتاب تناول الشيخ العلوم المعيارية واستهلها بعنوان تعديل الجهاز الدلالي أين بيّن تفريق علماء الشريعة بشكل واضح بين العقائد والشعائر فيجعلونها توقيفية وبين الشؤون المدنية فيجعلونها اجتهادية فلا يجوز لمسلم أن يعتقد في الله (العقائد) أو يتعبد الله (الشعائر) إلا بشيء منصوص عليه ولا يجوز للعقل أن يخترع عقيدة في الله، أو أن يبتكر عبادة جديدة.
أما العلوم والشؤون المدنية فهي اجتهادية يجوز للعقل أن يبتكر فيها ويبدع بشرط واحد فقط: أن لا تعارض الوحي.
وتناول الكاتب بعدها قضية التركيز على الرواة المكثرين، واستنكار بعضهم انفراد “أبي هريرة” رضي الله عنه بالأحاديث الكثيرة وناقش معها استشكالات أخرى عديدة.
ومن الآليات التي لجأ إليها المستكينون لهذه الثقافة المهيمنة للتخلص من النصوص، لتلافي الحرج النفسي بينهم وبين أنفسهم، والحرج الاجتماعي بينهم وبين الآخرين في مجتمعهم، توسيع وبعج مفهوم “نقد المتون” أي متون السنة النبوية.
وهدفهم من هذا الرد للأحاديث النبوية المخالفة للثقافة الغربية الغالبة قولهم: إنهم إنما أرادوا بذلك الدفاع عن النبي وليس القدح فيه وأن لا ينسب له ما يسيء له، وهي حجة مستهلكة يستترون بها في تحريف الشريعة لتوافق قيم الغالب.
وهكذا تلغى أحكام الجهاد والمرأة والكافر باسم الدفاع عن الإسلام من أن تتشوه صورته في الوعي الغربي.
وفي مناقشته سلط الكاتب النور على اختلاف جوهري بين مفهوم التجديد في العلوم الشرعية ومفهوم التجديد في العلوم المدنية، من خلال عرض مثالين نموذجيين هما “الشافعي” و”آينشتاين”، فالأول رمز للعلوم الشرعية والثاني رمز للعلوم المدنية. وكلاهما شعلة الإبداع في حقولهما. وبين الفارق الجوهري بين النموذجين أين يعتبر الاستحداث في العلوم المدنية مؤشر إبداع مطلوب بينما يمثل في العلوم الشرعية مؤشر تراجع وانحطاط.
ولا شك أن التأثر الخاطئ بقراءة تاريخ العلوم المدنية كالفلسفة والنظريات العلمية ومحاولة إسقاط فكرة الثورات والنظريات والتحولات الجذرية والانقلابات العلمية المفاهيمية على العلوم الشرعية، خطأ قاتل.
استراتيجيات فعّالة

وتحت عنوان استراتيجية اللابديل، يبين الكاتب أن الحياة مبنية على تقابل إرادتين، إرادة بشرية وإرادة إلهية، والنخب المثقفة المرتهنة للثقافة الغالبة تتألم من الارتطام المستمر بين رغبتها البشرية وإرادة الله الشرعية؛ فتصعد إلى تبديل مراد الله. فتصل إلى منطقة الخطر النهائي، إنه التعدي على الذات الإلهية.
وأوضح الكاتب أن صاحب إستراتيجية اللابديل لا يقدم لك -مثلًا- معنى للنص تناقشه، وتوازن بينه وبين تفسيرات الخطاب الشرعي السني، وإنما يقول لك النص لا نهائي التفسيرات، ويتوقف دون تعين، وهكذا حاله في كل المعارك والصراعات التي تدور بين هؤلاء المنهزمين وبين أهل السنة.
وفي الفصل الثالث تناول الكاتب نظام العلاقات، وابتدأ بتمييزات العلاقة بالمخالف، فتحدث أول ما تحدث عن المبادئ العامة لأهل السنة والجماعة في الموقف من المخالف، وسلط الضوء على نواة الخلل في الشعارات الثلاث المطروحة (الليبرالية، الحرية، والموقف من المخالف) الذي يتمثل في تأويل الأحكام الشرعية المعارضة للحرية الليبرالية للمخالف، لكنهم يتفاوتون في تأويل الشعار ويتفاوتون في مدى التأويل وحدوده.
وميّز الكاتب بين المسائل الظاهرة والاجتهادية، وبين الأصل والهفوة وبين الرأي المطوي والرأي المشهور، وبين مقام الدعوة ومقام الإنكار، وفي أغراض العبارات بحسب الأشخاص، وناقش مجموعة من الأقوال التي يظهر فيها التمييزات السنية في العلاقات بالمخالف، ومناقشة بعض التعابير المشحونة بمضمون ليبرالي، والتي راجت بسبب ضغط ثقافة الحرية الليبرالية الغالبة.
وتعرض الكاتب لتفكيك مفهوم الطائفية، أين جعله هؤلاء أصلًا يحاكمون الناس إليه. وخلص إلى أن لفظ الطائفية محدث وليس أصلًا شرعيًا يحاكم الناس إليه ونقد الطوائف التي ضلت عن شيء من الشريعة مطلب شعري وفريضة قرآنية وهم جعلوه عيبًا ومذمة!
وتحت عنوان لبرلة الولاء والبراء تناول الشيخ مسألة ضرورة إعادة قراءة الولاء والبراء، وقضايا بغض الكافر والزوجة الكتابية وغيره وكلها قراءات تستهدف بشكل مكشوف تخفيض مضمون الولاء والبراء ليقترب من نظرية الحرية الليبرالية، وأكد أن تصرفات متفقهة الثقافة الغالبة في لبرلة الولاء والبراء هي من أوضح النماذج والتطبيقات في تقديم المتشابه على المحكم وعاهة تعقيد الاستثناءات؛ أي تحويل الاستثناء إلى أصل والأصل إلى استثناء فالله أمر ببغض الكفار وأجاز نكاح الكتابية، فأخذوا الاستثناء وهدموا به الأصل، ولا زالوا في تشذيب الإسلام وقصقصته لأغراض التبسم في مؤتمرات إنشائية يخدع بها الحاضرون أنفسهم قبل أن يخدعوا غيرهم.
تناولت المناقشة أيضًا مفارقات لبرلة الخلاف، أين سلط الضوء على تناقضات الخاضعين لثقافة الحرية الليبرالية الغالبة الذين يتحدثون كثيرًا عن حرية المخالف حديثًا مخالفًا للشريعة وفي ذات الوقت ينتهكون حقوق المخالف الشرعية ذاتها. والتي صورها أحد أدباء القرن الثالث قائلًا: “يصول أحدهم على من شتمه ويسالم من شتم ربه”.
وأبرز الكاتب ظاهرة كسر الخصوصية العيدية التي انتشرت بكثافة مع ثورة الاتصالات الحديثة وتزايد الامتزاج بغير المسلمين فانسكبت أنماط حياة الأمم المهيمنة على مجتمعاتنا المستضعفة أنماط حياتها في الزي والطعام والحفلات، ومنها أعياد الكفار، التي غزت مناخنا الثقافي والاجتماعي، بسبب هذه المتغيرات الاتصالية المعاصرة.
وتزايدت بسبب ضغط هذه التقاليد الغربية المسيطرة الأصوات -التي تحاول شرعنة أعياد الكفار- تأويل المعطيات الشرعية التي تمنع مشاركة الكفار أعيادهم. في حين أن العيد شعيرة لها خصوصية ولا يجوز مشاركة الأمم الكافرة الغالبة أعيادها.
وعن آيات الغزو والجهاد، ناقش الكاتب كيف يحاول المستكينون لثقافة السلطة الغالبة تحريف مفهوم الجهاد ولي التأويلات التي تخص جهاد الطلب لمفهوم جهاد دفع فقط، ويخلص الكاتب إلى أهمية المحافظة على المفاهيم الشرعية ضد التزوير الذي يتم عبر تأثير موجة ومتنوع من ضغط الثقافة الغربية على النظم العربية لتمكين الخطابات الفكرية والدعوية المدجنة المنسجمة مع متطلبات النفوذ الأمريكي.
ومن أبشع تطبيقات الحريات الليبرالية التي ناقشها الشيخ والتي وقع فيها بعض الكتاب المحليين هو أنه طردًا لأصلهم في حرية المخالف التزموا بأن من سبّ النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز معاقبته بل يواجه الفكر بالفكر فقط.
وعبر قانون المتوالية الفكرية برزت انحرافات متتابعة في توسيع الحرية الليبرالية حتى وصل الأمر إلى هذه البشاعة في منح الحرية لمن سب النبي صلى الله عليه وسلم.
وعرض الكاتب نماذج من تعامل أئمة وفقهاء وقضاة المسلمين مع من مس بجناب النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما لا مساومة فيه البتة وما يعكس مكانة النبي في نفوس هؤلاء المسلمين فلنقارنها بمكانته عند ضحايا الحرية الليبرالية الغربية.
لقد ختم الكاتب مناقشاته التي كانت عبارة عن نماذج وعينات تكشف لنا كيف تؤثر الثقافة الغالبة في تأويل الأحكام الشرعية لإخضاعها لهيمنتها ومن درس هذه الأسئلة والنماذج دبّ إليه اليقين بأن القطب الذي تدور كرة الفكر اليوم حوله هو “سلطة الثقافة الغالبة”.
ما عرضناه ليس كل تفصيلات الكتاب، وإنما ملخص مما أورده الكاتب في صفحاته الممتعة، فكان طرحًا مميزًا ازدان بأسلوب سهل مدعم بالأمثلة الحية والتحليلات المتزنة والخلاصات الذهبية. فجزا الله الشيخ إبراهيم السكران عن أمة الإسلام خير الجزاء ونفع بعلمه وهمته وعبقريته.
مقتطفات أعجبتني

– أنا لا ألوم الغربي أن يقيم المسائل طبقًا لما تقرأه عينه الزرقاء. لكني ألوم العربي أن يقيم المسائل بعين مزرقة. صـ36
– وينبوع الإحداث في دين الله كله ناشئ بسبب “ضعف تعظيم السلف” في عمق علمهم وكمال ديانتهم، كما أن صحة تدين المرء واهتدائه في دين الله فرع عن تعظيم السلف واعتقاد كونهم أكمل منا دينًا وعلمًا. صـ53
– والمراد أن المسجونين في معتقلات الثقافة الغالبة يجعلون تحريف الأحكام الشرعية لتكون وسطًا بين فهم السلف والفكر الغربي؛ يجعلون ذلك هو الوسطية المحمودة التي جاء بها القرآن، والواقع أن هذه هي الوسطية المردودة التي ذمها القرآن. صـ61
– ومن يقول لك إننا يجب أن نطور أحكام الإسلام لتتناسب مع الذوق المعاصر، ففي مقولته هذه “معنى ضمني” يخفيه، وهو أنه يعتقد أن الذوق المعاصر أرقى من أحكام الوحي! صـ103
ليس الإسلام دينًا هشًا لنخشى عليه من الشبهات، بل قلوب بني آدم هي الهشّة وهي التي نخشى عليها، فنحن لا نخشى على الأرواح التي تحمل الوحي أن تخسره بشبهة عارضة. صـ184
– وهكذا كانت سيرة أئمة وفقهاء وقضاة المسلمين، لم يكونوا يعتبرون عبارة فيها غض من مقام النبوة مسألة “خلاف فكري” و”وجهات نظر” تتم مناقشتها على طاولة الحوار، بل كانوا يعتبرونها قضية تعرض على سيف القضاء الشرعي، بالطرق المشروعة، ويختص بتنفيذها ولي الأمر فلا يفتأ عليه. صـ235
وما يفسده اللسان من الأديان أضعاف ما تفسده اليد. “ابن تيمية”
سلطة الثقافة الغالبة لـ إبراهيم بن عمر السكران
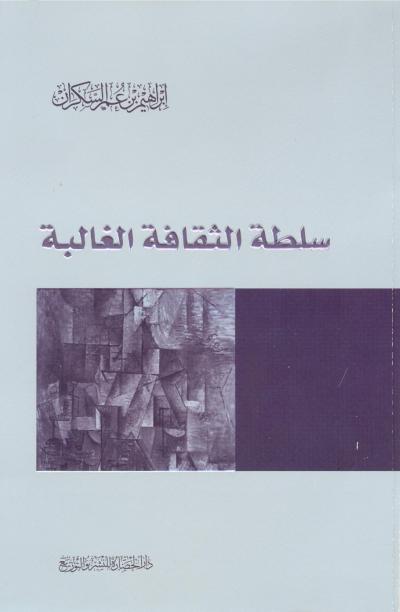
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق