عبر سبعة فصول وما يقرب من ثلاثمائة صفحة، يحاول فريد زكريا أن يستشرف آفاق عالم لا تهيمن أمريكا على مقدراته، ومع هذا يصف زكريا كتابه هذا بأنه ليس كتاباً عن سقوط أمريكا، ولكنه كتاب عن صعود الآخرين في العصر الذي يخطو إليه العالم اليوم، ويصف المؤلف عالماً لن تظل أمريكا فيه تهيمن على الاقتصاد العالمي، أو توزع الأدوار السياسية على أرجائه أو تطغى على ثقافاته. وهو يرى في صعود الآخرين المتمثل في نمو دول مثل الصين والهند والبرازيل وروسيا وغيرها، الحدث الأكبر في عصرنا هذا، والتحوّل الكبير الثالث للقوة في العصر الحديث.
هذا الحدث سوف يعيد تشكيل العالم، فأعلى البنايات وأكبر السدود وأكثر الأفلام مبيعاً وأكثر التليفونات المحمولة تقدماً، تنشأ كلها اليوم خارج الولايات المتحدة، وهذا النمو الاقتصادي يولد ثقة سياسية واعتزازاً قومياً، وربما أيضاً مشكلات عالمية.
ويؤكد زكريا على أن العالم على أعتاب عصر يجري تشكيله بمعرفة العديد من القوى العالمية الناشئة. وليس بمعرفة الولايات المتحدة وحدها. حيث لم تعد هي مركز العالم، ويتساءل عن الكيفية التي ستفهم بها الولايات المتحدة وتتعامل مع هذا المناخ العالمي سريع التغير الذي تتحول فيه الكثير من الدول والقوى إلى دول وقوى «غير أمريكية» دون أن تكون بالضرورة «معادية» لأمريكا؟ فما معنى أن تعيش في عصر من العولمة الحقيقية؟ وما معنى أن تعيش في عالم ما بعد أمريكا الذي تتبدى ملامحه مع بدايات القرن الواحد والعشرين؟ ولعل هذا السؤال المركب هو السؤال المحوري الذي يدور حوله موضوع الكتاب، والذي يسعى فريد زكريا للإجابة عنه بأسلوبه السلس وبصيرته النافذة وقدرته الفائقة على التصوّر.
ويضع الكتاب أمام القارئ - بقدر كبير من الصدق والأمانة - من الحقائق والوقائع والأرقام ما يمكنه من تفهّم دور الولايات المتحدة وغيرها من الدول الأخرى، وينقل إلى القارئ فهم المؤلف الواضح والدقيق للعلاقات الدولية والسياسات العالمية وقضايا التنمية الاقتصادية. وفي إطار هذه الأفكار أفرد المؤلف الفصل الأول من كتابه للحديث عن «صعود الآخرين».
في الفصل الثاني يطرح الكتاب عدداً من القضايا الحرجة وعلى رأسها التهديد الذي تمثله التنظيمات الإرهابية بالنسبة للحضارة المعاصرة، وهو يقلل من قيمة خطر هذه التنظيمات، ويرى أن المهم هو حرمانها من فرصة امتلاك أسلحة نووية تكتيكية، وأن ما عدا ذلك من عمليات إرهابية متمثلة في تفجيرات هنا أو هناك محدودة الأثر، مذكراً القارئ بأنه منذ أحداث سبتمبر 2001 لم يستطع تنظيم القاعدة شن أي هجوم رئيسي، وأن ذلك التنظيم الإرهابي تحوّل إلى ما يشبه شركة إعلام تنتج شرائط الفيديو في المناسبات أكثر مما تمارس العمليات الإرهابية. ويخلص إلى أن أفضل طريقة لمواجهة التنظيمات الإرهابية هو ألا نعيش نحن «مرهوبين».
عالم مابعد الانهيار
كما يتناول في هذا الفصل الآثار السياسية والاقتصادية لانهيار الاتحاد السوفييتي وسقوط حائط برلين في نهاية ثمانينيات القرن الماضي، مشيراً إلى أن هذا السقوط أسفر فجأة عن اتفاق عام على أنه لا يوجد سوى منهج واحد لإدارة اقتصاد أي دولة، مستعيراً عبارة مارجريت تاتشر في وصف الوضع الاقتصادي في العالم عقب انهيار الاتحاد السوفييتي «ليست هناك بدائل»، ثم يستدرك مذكّراً بأنه بالرغم من صيرورة العالم أكثر ترابطاً وتداخلاً خلال العقدين الماضيين، فإن المشاعر القومية في أنحاء العالم أطلت برأسها، كما لم يتصوّر أي من المراقبين المشدوهين بفوران العولمة.
يختتم زكريا هذا الفصل بأن يتنبأ بأن يلاحظ المؤرخون بعد أجيال عدة بشأن أيامنا الراهنة أنه في العقود الأولى من القرن الحادي والعشرين نجحت الولايات المتحدة في مهمة تاريخية كبيرة عندما استطاعت أن «تعولم» العالم، ولكنها في الوقت نفسه، نسيت أن تعولم نفسها.
في الفصل الثالث، يفاجئك الكتاب بتقديم صورة جديدة وغير مألوفة عن النمو السريع للعالم «غير الغربي»، حيث تحقق القوى الناشئة - لأول مرة في التاريخ - وعلى رأسها الصين والهند معدلات نمو تفوق نظيرتها في أوربا، وفي هذا السياق يتساءل المؤلف: هل يمكن أن يكون هناك مجتمع حديث دون أن يكون مجتمعاً غربياً؟ وإلى أي حد يختلف المعنيان؟ وهل سيكون المجتمع العالمي مختلفاً اختلافاً جوهرياً في ظل عالم تستحوذ فيه قوى غير غربية على وزن كبير ومؤثر؟ وهل ستكون لهذه القوى الجديدة قيم مختلفة؟ أم أن الثراء يمكن أن يجعل الجميع متشابهين؟ ولكي يدلل المؤلف على أهمية هذه الأسئلة يسوق حقيقة أن ثلاثة من بين أكبر أربعة اقتصادات في العقود القليلة القادمة ستكون اقتصادات غير غربية «اليابان والصين والهند» مع ملاحظة أن القوة الرابعة «الولايات المتحدة» يزداد فيها باستمرار حجم ودور السكان من أصول غير أوربية، ومع ذلك يخلص المؤلف إلى أنه مهما كان ثراء وعراقة الثقافات والحضارات غير الغربية، فإنها - في لحظة معينة من التاريخ - لا تستطيع أن تستغني عن الاستعارة من الحضارة الغربية، إذا أرادت أن تنجح اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً. ويشير إلى أن الشركات الكبرى في العالم - مهما كانت جنسياتها - لا بديل أمامها عن اتباع النظم الإدارية والفنية التي تنتمي بنشأتها إلى العالم الغربي. بل إن الدول التي ترغب في الاندماج في المجتمع الدولي لابد لها من تبني النظم الغربية في الحكم وإدارة الدولة.
في الفصل الرابع الذي خصصه لدراسة النهضة الحالية التي تشهدها الصين، والذي يحمل عنوان «المتحدي»، يذكّرنا المؤلف بمقولة نابليون «دع الصين نائمة، لأنه حينما تستيقظ الصين، فسوف ترج العالم». ويقول إن الصين - بعدد سكانها ومساحتها وحجم اقتصادها الضخم الذي يتزايد بسرعة غير مسبوقة - تصدم الأمريكيين بوجه خاص، حيث يمثل الولع بالضخامة ملمحاً مهماً من ملامح ثقافتهم. فالصين اليوم هي أكبر منتج للفحم والصلب والإسمنت في العالم، وهي أكبر سوق للتليفونات المحمولة، وفي سنة 2005 كان بها 28 مليار قدم مربعة من المساحات قيد البناء، أي خمسة أضعاف ما لدى الولايات المتحدة. وخلال الخمسة عشر عاماً الأخيرة نمت صادراتها للولايات المتحدة بنسبة 1600%. وهي تستحق اليوم لقب «مصنع العالم» الذي كان يطلق على بريطانيا في ذروة الثورة الصناعية. فهي تنتج ثلثي ماكينات التصوير وأفران الميكروويف ومشغلات الــDVD والأحذية في العالم.وتصدر لسلسلة محلات Wal-Mart الأمريكية وحدها ما قيمته 18 مليار دولار سنوياً من السلع منخفضة التكلفة، منخفضة الأسعار. وهي بذلك تضمن فرص العمل لـ4ر1 مليون أمريكي يعملون في هذه المحلات.
ويرصد المؤلف النجاحات الأخرى التي حققتها الصين خلال ثلاثة عقود، واصفاً إياها بأنها نجاحات مذهلة، حيث معدل نمو أعلى من 9% سنوياً في معظم السنوات الثلاثين الأخيرة، وهو أسرع معدل نمو يحققه اقتصاد كبير الحجم سجله التاريخ. وفي الفترة نفسها نجحت الصين في إخراج نحو 400 مليون من مواطنيها من دائرة الفقر، وهو أكبر إنجاز من نوعه في أي زمان أو مكان. وتضاعف متوسط دخل الفرد في الصين سبع مرات. وهكذا تكون الصين - بالرغم من النواقص والسلبيات - قد حققت على نطاق كبير حلم كل دولة في العالم الثالث، وهو التخلص من قدر كبير جداً من الفقر. ويستعير زكريا مقولة جفري ساتشز إذ يقول: «إن الصين هي أكثر قصص التنمية نجاحاً في تاريخ العالم».
ولكنه يشير إلى أنه بينما تساهم الصين مساهمة فعّالة في إعادة تشكيل الساحة العالمية سياسياً واقتصادياً، فإن الصين نفسها يعاد تشكيلها من قبل العالم الذي تصعد فيه. ويدلل على ذلك بأن الصين مشتبكة في الجدل القائم بين القوتين اللتين تشكّلان عالم ما بعد أمريكا، ألا وهما العولمة والقومية. فمن ناحية، تدفع الضغوط التكنولوجية والاقتصادية بالصين إلى التعاون مع العالم لدرجة الاندماج، ولكن هاتين القوتين نفسيهما تسببان إرباكاً وفوراناً اجتماعياً داخل المجتمع الصيني، حيث يسعى النظام الحاكم للبحث عن سبل لتوحيد مجتمع ينحو إلى التنوّع بشكل متزايد. وفي الوقت نفسه، فإن النمو الذي تشهده الصين يعني أنها تصير أكثر ثقة بنفسها، وأكثر ميلاً لاكتساب مزيد من التأثير والنفوذ في المنطقة وفي العالم.
ويخلص المؤلف إلى أن الاستقرار والسلام في عالم ما بعد أمريكا، سوف يعتمدان إلى حد كبير على نوع التوازن الذي ستستطيع الصين تحقيقه بين قوتي الاندماج وعدم الاندماج.
حلفاء وأعداء
ويفرد المؤلف فصلاً خاصاً للهند تحت عنوان «الحليف»، مؤكداً أن الهند هي أكثر دول العالم تأييداً لسياسات الولايات المتحدة، ويصفها بأنها أسرع اقتصادات السوق الحرة نمواً في العالم، ويعزو ذلك إلى شركات إنتاج التكنولوجيا الهندية والنظام الديمقراطي الهندي. وفي مقارنة بالاقتصاد الصيني يقول: إن ازدهار الأخير أصبح واقعاً مشهوداً للعيان، بينما ازدهار الاقتصاد الهندي لايزال شأنا مرهوناً بالمستقبل، حيث متوسط نصيب الفرد في الهند من الناتج المحلي الإجمالي لايزال 960 دولاراً فقط. ولكن هذا المستقبل مقبل بخطوات متسارعة. حيث من المقّدر للاقتصاد الهندي سنة 2015 أن يكون مساوياً للاقتصاد الإيطالي، وفي سنة 2020 سوف يلحق باقتصاد بريطانيا، وفي سنة 2040 سوف تحظى الهند بثالث أكبر اقتصاد في العالم. أما في سنة 2050 فسوف يصل متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى عشرين ضعفاً بالنسبة لمستواه الحالي. كما تتمتع الهند بتركيبة سكانية واعدة، فحيث يشيخ العالم الصناعي، سوف تستمر الهند في إنجاب الكثير والكثير من الشباب، أو بتعبير آخر من الأيدي العاملة، بينما الصين نفسها تعاني من فجوة شبابية بسبب نجاح سياستها الخاصة بطفل واحد لكل أسرة. ولكن الهند لديها وفرة شبابية غزيرة لأن خططها الخاصة بتنظيم الأسرة باءت بالفشل.
وعلى الرغم من ارتفاع معدلات الفقر الحالية في الهند، فهي تمثل نصف ما كانت عليه منذ عشرين عاماً. وقطاعها الخاص مفعم بالنشاط، حيث يحقق أرباحاً بنسب تقفز من 15 إلى 20 إلى 25% عاماً بعد عام. وهو يعمل بكل القطاعات الاقتصادية من الصلب إلى برامج الحاسوب. وقد ارتفعت إيرادات هذا القطاع في سنة 2006 من 17.8 إلى 22 مليار دولار بنسبة زيادة تصل إلى 23%. وعلى مدى السنوات الثلاث القادمة، سوف تستورد شركة جنرال موتورز وحدها من الهند ما قيمته مليار دولار من مكونات صناعة السيارات. ومن زاوية أخرى فإن عدد المليارديرات في الهند اليوم يفوق عددهم في أي دولة آسيوية آخرى، ومعظم هؤلاء المليارديرات كوّنوا أنفسهم بأنفسهم.
ويشير الكتاب إلى ملمح متميز من ملامح الاقتصاد الهندي لا يتوافر لأي اقتصاد نام آخر، وهو أن الخدمات تمثل 50% من الناتج المحلي الإجمالي، و25% للصناعة، و25% للزراعة. والدولتان الوحيدتان اللتان تملكان مثل هذه التشكيلة الاقتصادية هما اليونان والبرتغال، وهما من الدول ذات الدخل المتوسط التي تجاوزت المراحل الأولى من التصنيع الكبير الحجم، والتي تدخل الآن إلى اقتصاد ما بعد الصناعة.
ولكن من ناحية أخرى، تلك الدولة التي لديها أكثر من وادي سيليكون، لديها أيضاً أكثر من 300 مليون مواطن يعيشون على أقل من دولار واحد يوميا. وهي موطن 40% من فقراء العالم، وتضم ثاني أكبر عدد من حاملي فيروس الإيدز في العالم. ومع هذا، فالمؤلف يقول إن هذه الأوضاع والأرقام تشكّل ملامح اللقطة الثابتة، ولكن لو نظرنا إلى الصورة المتحركة فسوف يتغير تقييمنا لأوضاع الهند تغيراً كبيراً.
مصير أمريكا
ولعل أكثر فصول الكتاب استحقاقاً للتمعن والانتباه، والذي يحمل الرسالة المحورية في هذا الكتاب هو الفصل السادس الذي يحمل عنوان «القوة الأمريكية»، الذي يجري فيه المؤلف مقارنة بين صعود وسقوط الإمبراطورية البريطانية وبين الوضع الحالي للولايات المتحدة، ويتساءل: هل تلقى أمريكا المصير نفسه؟ أم أن هناك ما يمكن أن تفعله لتجنّب الانحدار إليه؟ وهو يرى أن هناك الكثير مما يمكن - ويتعين - أن تفعله الولايات المتحدة، لصالحها ولصالح العالم. فعلى الرغم من أن المأزق الاستراتيجي الرئيسي الناتج عن كون كل منهما في زمن معين اللاعب الدولي الوحيد في الساحة العالمية متشابها لدرجة مدهشة، فإن هناك أيضاً اختلافات جوهرية بين بريطانيا آنذاك والولايات المتحدة اليوم، فعندما حاولت بريطانيا أن تحافظ على وضع القوى العظمى، كان أكبر التحديات أمامها اقتصادياً أكثر منه سياسياً، أما بالنسبة للولايات المتحدة، فالوضع عكس ذلك، فمن خلال الاختيارات الاستراتيجية الصائبة والدبلوماسية الراقية نوعاً، كانت بريطانيا قادرة على أن تحافظ على أو حتى توسع من نفوذها لعقود عدة، وبالرغم من ذلك لم تستطع في النهاية أن تغير من حقيقة أن موقعها كقوة - ديناميتها الاقتصادية والتكنولوجية - كان يتآكل بقوة. لقد كانت بريطانيا تنحدر بنعومة ولكن على نحو لا يمكن إيقافه. أما الولايات المتحدة فهي تواجه اليوم مشكلة فريدة ومختلفة. فالاقتصاد الأمريكي (بالرغم من أزمته الحالية) لايزال في الأساس عفياً عندما يقارن بالاقتصادات الأخرى. والمجتمع الأمريكي مجتمع يتميز بالحيوية. ولكن النظام السياسي الأمريكي هو الذي لا يعمل على نحو صحيح، وغير قادر على القيام بالإصلاحات البسيطة نسبياً التي من شأنها أن تضع البلاد على قاعدة مستقبلية شديدة الصلابة. وتبدو واشنطن غير واعية لدرجة كبيرة بالعالم الجديد الذي ينهض من حولها، كما أنها لا تبدي علامات ذات شأن تفصح عن قدرتها على إعادة توجيه السياسات الأمريكية نحو هذا العصر الجديد.
وأخيراً يتطرق المؤلف إلى استعراض ما يسمّيه «الغاية الأمريكية»، مشيراً إلى أن موقف أمريكا قد تدنى بشكل غير مسبوق في الفترة من تسعينيات القرن العشرين، وحتى وقتنا الحالي، مشيراً إلى أن هناك تحوّلا في القوة لا يمكن إغفاله لصالح القوى الناشئة وهو ما يطلق عليه المؤلف «صعود الآخرين»، وإن كانت أمريكا لاتزال تهيمن على العالم سياسياً وعسكرياً، ويخلص إلى أن العالم الذي يبدو اليوم عالماً أحادي القطبية، لن يستمر طويلاً كذلك، وهو يرى أن هذا التحوّل المرتقب سيكون في صالح العالم وفي صالح أمريكا في الوقت نفسه، ذلك إذا تعاملت معه أمريكا بالمنهج الصحيح، وهو يضع أمام الإدارة الأمريكية مجموعة من الخطوط العريضة للخيارات التي ينصحها باتباعها لو أنها أرادت أن تحسّن التعامل مع هذا العالم الجديد.
قراءة وعرض كتاب (عالم ما بعد أميركا)
عماد خضر
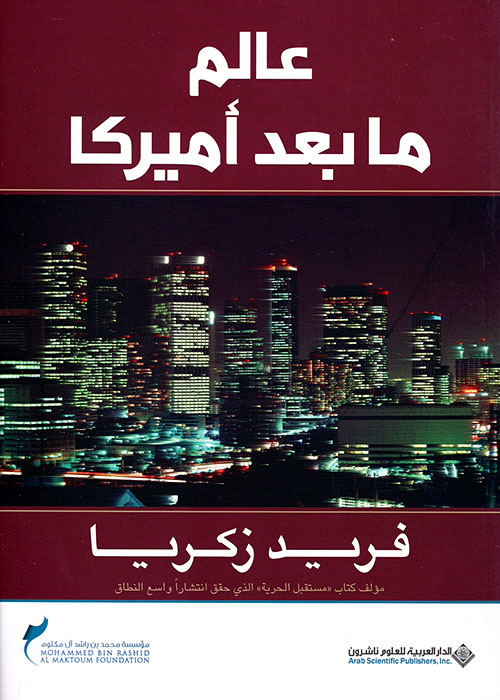
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق